الدين والسياسة
 حتى اليوم مازالت جدلية الدين والسياسة من أعقد التصورات عند المسلمين، وهم في حالة من الصراع الفكري، والاضطراب أيضاً حولها.
حتى اليوم مازالت جدلية الدين والسياسة من أعقد التصورات عند المسلمين، وهم في حالة من الصراع الفكري، والاضطراب أيضاً حولها.وقد كان هذا الصراع قديماً قائماً في الغرب حيث هيمنة الكنيسة والإمبراطور على حياة الشعوب، ثم قامت الثورات التي تخلصت من تلك الهيمنة، وأبعدت الدين بالكلية عن حياة الناس، ورأت فيه الرجعية والظلام، والاستبداد والكذب، والوهم والأسطورة..
وعمّق هذا البعد قيام الثورة الصناعية، وتقهقر المسلمين، وانهيار خلافتهم، وجرائم الكنيسة وفضائحها.. ولكن العلمانية أخذت مراحل كثيرة في التطور، لأنها قامت واستقرت بعض حروب طاحنة ضاع فيها مئات الملايين من البشر ! واستقر النظام العلماني العالمي على المبدأ "الديمقراطي الرأسمالي" وهو امتداد للحضارة الرومانية سلوكاً، والإغريقية فكراً؛ بكل إباحيتها وفلسفاتها في الحياة والصراع على المادة، وأصبحت "الديمقراطية الرأسمالية الليبرالية" قمة التطور السياسي والاقتصادي لدى الغرب، وأصبحت الحرية في الفجور والعري والإباحية مطلقة بدون أي قيد من دين أو قانون أو أخلاق، وبقي النظام الديمقراطي أفضل من النظام الاستبدادي المتعنت، لما في الديمقراطية من صور: الرقابة، والمحاسبة، والعزل. ولكن بقيت الرأسمالية تستعبد الشعوب، وتمتص دمائهم، وتسترق حياتهم، وتجعلهم مجرد "موارد بشرية" لشركات حفنة قليلة من المرابين وسُراق الثروات؛ وعندما يبدأ الاستغناء عن هذه الموارد البشرية، أو تقليص عددها، أو ظلمها تشريعياً، أو اجراءات تقشف تقطع عليهم التمتع بحرية الإباحية؛ تبدأ المسيرات والتظاهرات التي تسمح بها الديمقراطية ! هذا باختصار ما حصل من صراع بين الدين والسياسة في الغرب.
أما عند المسلمين: فالصراع ضارب بجذوره في عمق التاريخ منذ معركة صفين حتى اليوم، ومرّ المسلمون بأطوار شتى في علاقة الدين بالسياسة ( سياسة الحكم والمال ونظم الحياة ) فالمرحلة الأولى: مرحلة الرشد حيث هيمنة الدين على ( الروح والمجتمع والدولة ) والمرحلة الثانية: مرحلة الاستبداد حيث اتخاذ عباد الله خولاً - عبيداً للملوك - وماله دُولة بينهم، وكتاب الله دخلاً يتخذون منه وسيلة لتثبيت شرعيتهم، وبغيهم ! ثم المرحلة الثالثة: سقوط الوحدة السياسية للمسلمين، وانتهاك السيادة على بلادهم تحت وقع هجمات الاستعمار - الاحتلال - الدولي لبلاد المسلمين، وتقسيم بلادهم، ونهب ثرواتهم، وإفساد قيمهم، وتولية رجالاتهم على المسلمين.
***
وفي "محاولة التغيير" للعودة إلى المكانة السابقة للدولة الإسلامية، والأمة المسلمة.. وقع الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين، فأما الإسلاميين: فقد وقعوا في خطأ فاحش، وهو استخدام قوة الدين كوسيلة لنصرة جماعاتهم وأحزابهم ومواقفهم، كما أن سقوط الفقه السياسي الراشد، بفعل تقديس "فقه الملك العضوض" في أمور السياسة من جانب، وتقديم أنفسهم أحياناً كثيرة كعلمانيين بنكهة إسلامية من جانب آخر؛ جعلهم بلا مشروع سياسي راشد حقيقي، وأما العلمانيين: فمنهم من يريد تحييد الدين عن الصراع السياسي منعاً لاحتكاره من قبل جماعة أو حزب أو لجهالتهم بالتصور السياسي الإسلامي الراشد، أو تعميم بعض الممارسات الخاطئة على الجميع، أو التبعية والانبهار بالغرب، أو طمعاً في دنيا. ومنهم من هو كاره للدين ابتداء، ولما أنزل الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. ومازال هذا الصراع قائماً حتى اليوم !
***
إذن.. فما هي علاقة الدين الإسلامي بالسياسة، وكيف تكون هذه العلاقة سوية صحيحة مستقيمة ؟
في البداية الإسلام جاء ليحكم، هذه حقيقة أولية يجب أن تكون مستقرة في عقولنا، وشريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاءت لتسود، لتسود في أمر السياسة والحكم والمال، كما جاءت لتسود في أمور العبادات والصلوات، كما جاءت لتسود في الأخلاق والقيم والتصورات والموازين، كما جاءت لتسود في التشريعات والقوانين.
وإن تحكيم الشريعة - في مجال النظام - في الدولة المسلمة، يبدأ من سياسة الحكم والمال، وتولية الأصلح من خلال نظام الشورى المناسب لكل مرحلة حضارية تمر بها الأمة، والحاكم مجرد عامل عند الأمة، يقودها بكتاب الله ليس له من نصيب في المال أكثر من غيره من المسلمين، وليس له حق في توريث الحكم لأحد من بعده، وأما سياسة المال، فالثروة والمال حق خالص للأمة، يُوزع كما أمر الله، بلا محاباة ولا تمييز ولا استئثار، ولهذا جاء التنبيه النبوي باتباع سنته - في كل شيء - وسنة الخلفاء الراشدين المهديين في سياسة الحكم والمال.
فالدين الإسلامي يُمثل القوة الروحية، والاجتماعية، والفكرية، والتعبدية بالنسبة للمسلمين، وهو الهوية الجامعة لهم.
ولكن الذي يحدث أثناء الانحراف عن الرشد.. أن يُستخدم الدين كقوة سياسية يحتكرها حزب أو جماعة، فتجعل من نفسها المتحدث الرسمي باسم الدين، أو هي وحدها الفرقة الناجية المنصورة، أو التلاعب بعواطف الناس لتبرير مواقفها وأخطائها باسم الدين، أو جعل الإسلام كميراث للأبناء لا يحق لأحد أن يأخذ منه إلا بإذن الحزب أو الجماعة.. والحق إن ذلك من أفحش صور الصد عن سبيل الله، والإساءة إلى الإسلام.
والصورة الصحيحة: إن المسلمين كونهم مسلمين لا يسعهم إلا أن يَحكموا ويُحكموا بالإسلام، فهذه صورة الحرية التي يريد الله فيها للإنسان أن يتحرر من النظم الوضعية، والتشريعات البشرية، ليكونوا أحراراً أمام سيد واحد.. جل جلاله.
فهناك فرق أن يكون الدين هو القائد، وأن يكون هناك أشخاص تركب الدين وتتخذ من كتاب الله مطية لتحقيق أغراضها السياسية ! فالسلطان السياسي للمسلمين، هو "كتاب الله" وشرط الولاية والشرعية علينا "ما أقام فيكم كتاب الله". وبذلك فهو القوة الروحية والسلطة العامة لكل المسلمين. ولا يحق لأحد أن يتخذه كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية.
وإن المسلمين لا يسعهم إلا أن يقوموا بأمر هذا الدين وأن يكون هو الاختيار الأوحد لهم، لا يحيدون عنه. وليس هو أداة للتلاعب الحزبي، أو الصراع الانتخابي.
وليس في الإسلام صورة الحاكم بأمر الله، ولا ظل الله في الأرض، ولا يحكم أحد باسم الحق الإلهي المقدس ! فكل هذه صور من انحرافات الكنيسة في عصورها الوسطى المظلمة، إنما الحاكم ونظامه.. يحكم بأمر الأمة التي اختارته، وقدّمته لهذه المهمة، والحاكم والأمة خاضعون جميعاً لسلطان الكتاب.
والمؤسسات الدينية مثل: المسجد والمنبر والقضاء الشرعي والجامعات ومؤسسات الفتوى وغيرها، ليست في خدمة الحاكم ونظامه، وليست تابعة له، بل هي مؤسسات مستقلة حيادية؛ تعمل في خدمة الدين والشرع، وحماية وصيانة الأمة، ولها حق الاعتراض والاحتساب على الحاكم وكافة مؤسساته التنفيذية، وتقوم بواجبها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بكل صدق وإخلاص وموضوعية، وتدور مع الكتاب - لا الحاكم - حيث دار.
وعليه؛ فإن الحركة السياسية لكل المسلمين لا بد أن تكون إسلامية باسم الله ! دون احتكار المشروع الإسلامي، أو التحدث الحصري باسمه.. بل إن كل جماعة أو حزب - أو أي صورة من صور الاجتماع - يُقدم نفسه على أن حركته مجرد "اجتهاد" لا حق مطلق فيه، ولا كفر وإيمان فيه.. بل مجرد اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، والخطأ محمول على فهم وحركة أصاحبه لا على الإسلام ذاته. وفي ذلك الاجتهاد فليتنافس المتنافسون.
وبالعموم.. فالإسلام يواجه الواقع بالوسائل المكافئة له، ويواجه قوة الباطل.. بقوة الحق. ويمضي في طريق السنن الإلهية، ويحقق سنن التغيير في هذا الواقع، دون انتظار صورة سحرية غامضة الأسباب لمجرد كونه مسلم !.
والصحيح.. إن الأمة هي التي تقوم بأمر دينها، وتقوم بالمهمة التي من أجلها أخرجها الله تعالى للناس، ولا تجعل الحاكم يتلاعب بالدين من أجل غرض سياسي، فهي حامية الدين، وتمنع الحاكم أن يُصور نفسه للناس أنه هو الإسلام، وغيره هو الفتنة والضياع؛ وبذلك يسهل مراقبة الحاكم، وعزله، ومحاسبته من خلال مؤسسات الأمة المختلفة، التي تستطيع أن تحقق أقصى فاعلية لمفهوم "الشورى" بمعناه الواسع والشامل.
وهذه الحركة السياسية تحتاج إلى الصدق الخالص - لا سيما في هذا الصراع العلماني الإسلامي - دون رغبة في شرف أو رياسة أو مال، ويحتاج إلى فقه سياسي راشد نقي من لوثات "الملك العضوض" ويحتاج إلى تنوع في الطرح بعيداً عن "الغلو" و"العصبية الجاهلية" اللذان يؤديان إلى "البغي" على الآخرين، فيُحبط البغي النصر والتمكين، ويُمتع أصحابه إلى حين ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ.
***

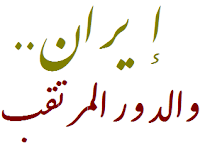

تعليقات
إرسال تعليق